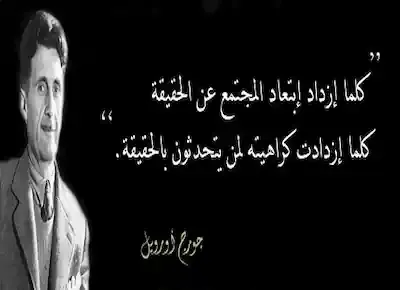1984 (10)
لم يكن ونستون يدري أين هو! كان يُفترض أنه
في وزارة الحب، لكن كيف السبيل للتحقق من ذلك.
كان قابعًا في زنزانة عالية السقف لا نوافذ
لها، وكانت جدرانها مغطاة بالخزف الأبيض اللامع، وكانت كانت مصابيح مخفية تغمرها
بفيض من الضوء الباهر، كما كان هناك طنين مستمر ظن ونستون أن له علاقة بفتحات
التهوئة بالزنزانة. وبمحاذاة جدران الزنزانة امتد مقعد خشبي مستطيل لا يتسع عرضه
للجلوس عليه إلا بصعوبة، وفي الجانب المقابل للباب كان هنالك مرحاض بلا كرسي
يستعمل لقضاء الحاجة، وفي كل جدار من جدران الزنزانة الأربعة ثبتت شاشة رصد.
وكان ونستون يشعر بألم مبرح ومتواصل في بطنه
رافقه منذ أن اقتادوه وقذفوا به في الشاحنة المغلقة التي نقلته. ولكنه كان يشعر
أيضا بجوع قارص وشديد، فلربما مضى على آخر مرة ذاق فيها طعاماً أربع وعشرون أو ست
وثلاثون ساعة. ولم يستطع، كما لن يتسنى له، أن يعرف إن كانوا قد ألقوا القبض عليه
في الصباح أو المساء.
جلس ونستون فوق المقعد لا يحرك ساكناً وقد
عقد ذراعيه حول ركبتيه، وكان قد تعلّم أن يجلس بلا حراك بعدما أدرك أن أي حركة غير
متوقعة يأتي بها تجعل صوتاً ينبعث من شاشة الرصد ينهره عن ذلك. واشتدت وطأة الجوع
عليه، ومع ذلك لم يشته أكثر من كسرة خبز تذكر أن لديه بعضاً منها في جيب معطفه كان
يشعر بها من حين لآخر تخز ساقه. وبعد طول تردد، تغلب إحساسه بالجوع على خوفه فدس
يده في جيبه.
ولم يكد يفعل حتى استوقفه صوت صارخ من شاشة
الرصد: «سميث! سميث ونستون رقم 6079، أخرج يدك من جيبك، هذا غير مسموح به في
الزنزانة!»
فعاد إلى سكونه الذي كان عليه وعقد ذراعيه
حول ركبتيه. وتذكر كيف أنهم قبل أن يجيئوا به إلى هنا قد ذهبوا به إلى مكان آخر
يرجح أنه سجن عادي أو مركز توقيف تستخدمه الدوريات، لكنه لم يستطع أن يعرف كم من
الوقت أمضى هناك فقد كان يتعذر عليه قياس الوقت، كان مكانا صاخبا تتصاعد منه روائح
كريهة. كانت زنزانة أشبه بتلك التي يقبع فيها الآن وان كانت أشد قذارة وتكتظ بعشرة
أو خمسة عشر سجيناً أغلبهم من المجرمين العاديين وقليلهم من السجناء السياسيين.
وهناك جلس صامتاً وقد أسند ظهره للحائط فيما كانت تزاحمه أجساد قذره، ورغم أن
الخوف والألم قد استحوذا عليه وصرفاه عن كل ما حوله، فقد استطاع ملاحظة الفارق
الواضح بين تصرفات السجناء من أعضاء الحزب وتصرفات السجناء العاديين، فالسجناء
الحزبيون كانوا دائماً يلزمون الصمت وتبدو عليهم علامات الخوف والرعب، أما
المجرمون العاديون فكانوا لا يأبهون ولا يبالون بأحد حتى أنهم كانوا يكيلون السباب
للحراس، ويدافعون عن أمتعتهم بشراسة ويكتبون الكلمات البذيئة على الأرض ويأكلون
الطعام المهرب من خارج السجن بل وكانوا يصرخون في وجه شاشة الرصد حينما توجه إليهم
عبرها الأوامر بالتزام الهدوء. ومن جهة أخرى كان بعضهم يبدو وكأنه على علاقة تفاهم
مع الحراس فينادونهم بأسمائهم رافعين الكلفة فيما بينهم ويحصلون على السجائر عبر
ثقوب التجسس التي في الباب، كما كان الحراس يعاملون المجرمين العاديين بشيء من
الصبر والأناة حتى حينما كانت الظروف تقتصي الغلظة معهم. وكانت تدور بينهم أحاديث
كثيرة حول معسكرات الأشغال الشاقة وهي المكان الذي يساق إليه غالبية السجناء، ومن
هذه الأحاديث استشف ونستون أن الحياة في هذه المعسكرات لا بأس بها إذا استطاع
السجين أن يكوّن علاقات جيدة وأن يعرف كيف يصرّف أموره داخل المعسكر. وكانت
ممارسات مثل الرشوة والمحاباة والعربدة بكل ألوانها، والشذوذ الجنسي والدعارة
تتفشى داخل هذه المعسكرات، بل كان يتم الحصول على المشروبات الروحية عبر تقطيرها
من البطاطس. ولم يكن أحد يحظى بثقة الحراس إلا المجرمون العاديون وبالأخص القتلة
وأفراد العصابات منهم والذين كانوا يمثلون شكلا من أشكال الأرستقراطية. وأما
المجرمون السياسيون فقد كان يعهد إليهم بجميع الأعمال القذرة.
ورأى ونستون أن سجناء من شتى الألوان يفدون
إلى السجن أو يخرجون منه في حركة لا تتوقف، فمنهم تجار المخدرات واللصوص وقطاع
الطرق وتجار السوق السوداء ومدمنو الخمر والعاهرات. وكان بعض مدمني الخمر يصلون
إلى حالة من الانفلات تضطر بقية زملائهم للتكتل ضدهم والسيطرة على هذا العنف، كما يذكر
أن أربعة حراس قد جاؤوا بامرأة ضخمة الجسم يناهز عمرها الستين وذات شعر أشيب
ونهدين كبيرين وكانت تقاومهم بعنف وتصرخ فيهم وهم يجرونها إلى الزنزانة من أطرافها
الأربعة، وفي النهاية جردوها من حذائها الذي كانت تركلهم به ثم دفعوها بعنف فسقطت
فوق حجر ونستون وكادت تكسر عظامه، لكنها نهضت واندفعت نحو باب الزنزانة وهي تلعن
الحراس وتسبهم بأقذع الكلمات، وحينما انتبهت إلى أنها كانت تجلس على شيء غير مستو
انزلقت عن ركبة ونستون إلى المقعد قائلة:
«معذرة يا عزيزي، ما كان يجب أن أجلس فوق
ركبتيك، ولكن هؤلاء الأوغاد هم الذين دفعوني. إنهم لا يعرفون كيف ينبغي أن يعاملوا
سيدة»، ثم توقفت عن الكلام وضربت بيدها على صدرها وهي تقول: «معذرة فلست في حالة
طبيعية».
وانحنت إلى الأمام وتقيأت على الأرض.
وبعد ذلك أسندت ظهرها إلى الحائط مغمضة
عينيها وقالت: «هذا أفضل، إياك أن تبقيه في معدتك، يحسن بك أن تتخلص منه وهو
طرياً».
وحينما هدأت قليلاً، التفتت لتلقي نظرة أخرى
على ونستون، وبدا أن آصرة من نوع ما قد جعلتها تميل إليه فأحاطت كتفيه بذراعها
وجذبته نحوها وهي تنفث في وجهه بأنفاس مشبعة برائحة الجعة وحموضة القيء.
وسألته: «ما اسمك عزيزي؟»
فأجاب: «سميث».
فقالت: «سميث؟ هذا أمر عجيب، إن اسمي سميث
أيضاً»، ثم أضافت بنبرة حانية: «ربما كنت أمك!»
وجال بخاطر ونستون أنه من المحتمل فعلاً أن
تكون أمه، فقد كانت في مثل عمرها وجسمها وإن كان من الوارد أن بعض التغيير قد طرأ
عليها بعد عشرين سنة أمضتها في معسكر الأشغال الشاقة.
وما من أحد آخر تحدث مع ونستون، إذ كان
المجرمون العاديون يتجاهلون السجناء السياسيين تجاهلاً يثير الدهشة، بل وينظرون
إليهم نظرة ازدراء. وأما السجناء السياسيون فكانوا دائمي الصمت فهم يخشون الكلام
مع أي من المجرمين العاديين، كما أنهم أشد خشية من الكلام بعضهم مع بعض. ولم يحدث
سوى مرة واحدة أن استرق السمع لحديث هامس دار بين سجينتين من سجينات الحزب ولم
يفهم منه سوى أنه كان يدور حول ما يدعى بالغرفة (101) لكنه لم يدرك المغزى.
لعلهم قد جاؤوا به إلى هنا قبل ساعتين أو
ثلاث ومع ذلك لم يفارقه ألم معدته لحظة من الزمن، وإن اشتد عليه حيناً وخف حيناً
آخر، وكان نطاق تفكيره يتسع أو يضيق تبعاً لذلك، فحينما كان يشتد عليه الألم كان
لا يفكر إلا في الألم ذاته وفي رغبته في الطعام، أما حينما يخف فكان الرعب يمسك
بتلابيبه، كما مرت به لحظات كان يتراءى له خلالها المصير الذي ينتظره وهو ما كان
يرتجف له قلبه وتتوقف أنفاسه. فقد كان يتخيل وطأة الهراوات وهي تحطم مرفقيه
والأحذية ذات النعال الحديدية وهي تهشم ساقيه، كما تراءى له وهو يُسحل فوق الأرض
ويصرخ طلباً للرحمة بعد أن تهشمت أسنانه. وقلما كانت ترد جوليا على خاطره لأنه كان
لا يستطيع أن يركز تفكيره عليها، نعم لقد أحبها ولن يخونها، (ولكن هذا الحب كان
مجرد حقيقة يعرفها معرفته لمبادئ الرياضيات) ولذلك لم يعد الآن يجد أثراً لأي حب
نحوها، بل لم يعد حتى يشغل باله بما عساه ألمَّ بها. ولكن أوبراين كان هو الذي
يخطر بباله كثيراً فيعيد إليه بصيصاً من الأمل، فيقول لنفسه لا بد أن أوبراين قد
علم بأمر اعتقاله، لكنه تذكر أن حركة «الأخوة» لا تحاول أبداً إنقاذ أعضائها، إلا
أنه تبقى أمامهم دائماً شفرة الحلاقة التي يمكنهم أن يهربوها إليه ليضع بها حداً
لآلامه. وتصور أن خمس ثوان تكفي لأن يمزق نفسه بالشفرة وببرودة حارقة، بل إن
الأصابع الممسكة بالشفرة ستتقطع حتى العظام هي الأخرى قبل أن يندفع إليه الحراس
لمنعه من ذلك. وكان كل شيء يرتد على جسمه العليل الذي كان يرتجف من أقل ألم، ومع
ذلك لم يكن واثقاً بأنه سيستخدم الشفرة حتى إذا أتيحت له الفرصة، فقد كان من
الطبيعي لديه أن يعيش لحظة بلحظة مفضلًا الحياة على الموت حتى لو كان على يقين من
أن تلك الحياة لن تتجاوز عشر دقائق وستكون كلها عذاباً في عذاب.
وكان ينصرف أحياناً إلى إحصاء عدد بلاطات
الخزف الأبيض على جدران الزنزانة، ومع أن الأمر كان يبدو هيناً فانه لم يوفق إلى
ذلك. وكثيراً ما كان يتساءل عن مكان وجوده وعن الوقت أهو ليل أم نهار. فتارة يشعر
بأنه من المؤكد أن ضوء النهار يملأ الكون خارج الزنزانة، وتارة أخرى وفي الوقت
نفسه تقريباً يشعر أن ظلاماً دامساً يخيم على العالم بالخارج. كان ونستون يعلم
بالغريزة أن الأنوار في هذا المكان لا يمكن أن تطفأ، إنه ذلك المكان الذي لا ظلمة
فيه، الأن فطن إلى السبب الذي جعله يظن أن أوبراين فهم إشارته عندما حدثه عن
المكان الذي لا ظلام فيه، ففي وزارة الحب ليس ثمة نوافذ وزنزانته ربما تكون في قلب
البناية أو عند الحائط الخارجي، وقد تكون في الطابق العاشر تحت الأرض أو في الطابق
الثلاثين فوق الأرض. وقد راح ونستون ينتقل بمخيلته من مكان لآخر محاولاً أن يقرر
بحسه العام ما إذا كانت زنزانته معلقة في الهواء أم مدفونة في أعماق سحيقة.
سمع ونستون وقع أقدام خارج الزنزانة، بعدئذ
فُتح الباب الفولاذي محدثاً صريراً عاليًا ودخل منه ضابط شاب يرتدي بزة سوداء يلمع
جلدها المصقول وكان ذا وجه شاحب يشبه قناعاً من الشمع، وما إن دخل الزنزانة حتى
أشار إلى الحرس أن يُدخِلوا السجين الذي كانوا يقتادونه والذي لم يكن غير الشاعر
أمبلفورث. أدخلوه الزنزانة وهو يجرجر قدميه ثم غادروا وأغلقوا الباب خلفهم.
راح أمبلفورث يتحرك داخل الزنزانة من طرف إلى
طرف كما لو أنه يبحث عن باب للخروج، وبعدئذ أخذ يذرع الزنزانة جيئة وذهاباً، ولم
يكن قد انتبه إلى وجود ونستون بعد رغم أن عينيه الزائغتين كانتا تحدقان في الجدار
الذي يتكئ إليه ونستون. كان أمبلفورث حافي القدمين وكانت أصابع رجليه الكبيرة
القذرة تبرز من ثقوب جوربه المهترئ ولحيته الكثة تغطي وجهه حتى عظم وجنتيه مضفية
عليه هيئة وحشية كانت تتلاءم على نحو غريب مع هيكله الضخم وحركاته العصبية.
حرّك ونستون نفسه من سباته عازماً على الحديث
مع أمبلفورث مهما كانت العواقب، فربّما كان هو من يحمل شفرة الحلاقة إليه.
فناداه: «أمبلفورث».
لم يصدر أي صوت عن شاشة الرصد، في حين توقف
أمبلفورث وقد جفل جفلة خفيفة، ثم ركز عينيه على ونستون وقال:
- آه! ونستون! أأنت هنا أيضاً؟
- لماذا جيء بك إلى هنا؟
- الحق أقول لك ...، قال ذلك وهو يجلس قلقاً
على المقعد قبالة ونستون، إنه جرم واحد لا غير.
- لكن هل اقترفته فعلاً؟
- يبدو لي أنني فعلت ذلك.
وفرك أمبلفورث جبينه بيده وضغط عليها للحظة
كأنما يحاول أن يتذكر شيئاً ما.
ثم قال على نحو غامض: «إن مثل هذه الأشياء
ممكنة الحدوث، فيمكنني أن أحدد لك حادثاً لعله هو السبب في مجيئي إلى هنا، إنه ولا
ريب حماقة من جانبي. فقد كنا نعمل في إنتاج طبعة من قصائد كبلنج وأبقيت على كلمة
«الله» في نهاية أحد الأبيات وكان لا بد من الإبقاء عليها لملاءمة القافية». وأضاف
وقد علت علامات السخط على وجهه: «لقد كان من المستحيل تغيير البيت الشعري، وقد
حاولت على مدى أيام التفكير في بديل لكن دون جدوى».
وتغيرت أسارير وجهه وذهب عنه الغضب وبدا
للحظة راضياً حيث شاع في وجهه شيء من دفء الثقافة، إنه ابتهاج المتحذلق الذي اكتشف
حقيقة لا قيمة لها.
وأردف قائلاً: «هل خطر ببالك أن تاريخ الشعر
الإنجليزي كان محكومًا بحقيقة أن اللغة الإنجليزية فقيرة في الأوزان؟»
ولم يكن ذلك السؤال قد خطر ببال ونستون
مطلقا، فضلا عن أن مَنْ في مثل ظروفه لا يأبه أو يهتم بذلك.
فسأله ونستون: «هل تعرف في أي وقت من اليوم
نحن الآن؟»
وبدا أن أمبلفورث جفل ثانية وقال: «قلّما
فكرت في ذلك، إنني حتى لا أذكر مذ كم يوم أُلقي القبض علي؟ مذ يومين أم ثلاثة؟»
وراح يقلب عينيه في جوانب الغرفة كمن يأمل أن يجد نافذة، ثم أضاف: «في هذا المكان
لا فرق بين الليل والنهار ولست أدري كيف يمكن للمرء أن يقدر الزمن فيه».
واستمر حديثهما الهائم بضع دقائق ثم ومن دون
سبب واضح صدر صوت عن شاشة الرصد يأمرهم بالتزام الصمت. فعاد ونستون لسكونه وقد عقد
ذراعيه حول ركبتيه. أما أمبلفورث فقد حال بنيانه الضخم بينه وبين الجلوس مرتاحاً
على المقعد الصيق، وراح يتململ في جلسته ناقلاً يده من ركبته هذه إلى تلك. إلا أن
صوتاً نبعث ثانية من شاشة الرصد يأمره بالسكون. ومرَّ وقت وهما على هذه الحال،
ربما عشرون دقيقة أو ساعة، ثم سمعا ثانية وقع أقدام خارج الزنزانة، فتجمد الدم في
عروقه، وجال بخاطره ألن وقع الأقدام تعني أن دوره قد حان، ربما حالا وربما خلال دقائق.
وفُتح الباب ليدخل منه الضابط الشاب ذو الوجه
المتجهم. وبحركة خاطفة من يده قال للحراس وهو يشير إلى أمبلفورث: الغرفة 101.
نهض أمبلفورث ومشى مهرولاً بين يدي الحراس،
وقد بدا وجهه مضطرباً رغم أنه لم يفهم ماذا يراد به.
ثم مضى وقت بدا لونستون طويلاً، وعاوده ألم
معدته. وراحت أفكاره تدور في حلقة مفرغة مثل كرة تدور وتسقط في المجموعة نفسها من
الفتحات، إذ لم يكن يفكر إلا في ستة أمور هي: ألم معدته، وكسرة الخبز التي في
جيبه، والدم والصراخ، وأوبراين، وجوليا، وشفرة الحلاقة. ثم اعترته نوبة تشنج جديدة
في أحشائه لدى سماعه وقع أقدام الحراس وهم يقتربون نحو الزنزانة. وما إن فتح الباب
حتى هبت موجة باردة من العرق كانت تتقدم بارصون الذي أدخله الحراس إلى الزنزانة،
والذي كان مرتدياً قميصاً رياضياً وسروالاً قصيراً.
وهنا جفل ونستون حتى أنه نسي نفسه وقال
مشدوها: «حتى أنت هنا؟»
ورمق بارصون ونستون بنظرة خلت من أي اهتمام
أو دهشة لكنها كانت مفعمة بالبؤس، وراح يذرع الغرفة جيئة وذهاباً بخطى غير منتظمة
وبصورة توحي بأن زمام نفسه قد أفلت منه. وكان كلما حاول مد ساقيه القصيرتين
أصابتهما رعشة، وعيناه كانتا جاحظتين تنظران باندهاش وكأنهما تحدقان في شيء بعيد.
فسأله ونستون: «ما الذي جاء بك إلى هنا؟»
فأجاب بارصون منتحباً: «جريمة فكر». كانت
نبرة صوته توحي بإقرار كامل منه باقتراف الجريمة وبرعب يعتمل بداخله كلما تذكر أنه
يقع تحمت طائلة هذا الاتهام، ثم وقف قبالة ونستون وكأنما يحتكم إليه، فقال: «أتظن
أنهم سيعدمونني رمياً بالرصاص؟ إنهم لا يرمون المرء بالرصاص إذا لم يقترف إثماً
ملموساً، أما مجرّد الأفكار فهذا ما لا سلطة للمرء عليه، أليس كذلك؟ أعلم أنهم
يمنحون المرء فرصة كافية للإدلاء بأقواله، إنني أثق بهم فيما يخص ذلك. إنهم يعرفون
سجلّي، أليس كذلك؟ لعلك تعرف أي نوع من الرجال كنت، لم أكن رجلاً سيئاً بأي شكل، صحيح
أنني لم أكن متقد الذكاء ولكنني كنت متحمساً وبذلت كل ما في وسعي لخدمة الحزب،
أليس كذلك؟ ألا تظن أنني سأفلت من عقوبة الموت وأنال خمس أو حتى عشر سنوات أمضيها
في معسكر من المعسكرات؟ إن من هو مثلي يمكنه أن يؤدي أعمالا مفيدة في معسكرات
الأشغال الشاقة، إنني لا أظنهم سيعدمونني رمياً بالرصاص لخروجي عن الطريق القويم
مرة واحدة».
وسأله ونستون: «هل أنت مذنب؟»
فأجابه بارصون باكياً وهو ينظر إلى الشاشة
نظرة خنوع:
«بالطبع إنني مذنب. وهل تظن أن الحزب يمكن أن
يعتقل شخصاً بريئاً؟» وهنا بدا وجهه الشبيه بالضفدع أكثر هدوءاً، بل وارتسمت عليه
علامات الاستقامة الزائفة، ثم استطرد قائلاً وعلامات التأثر بادية عليه:
«إن جريمة الفكر جريمة فظيعة، إنها جريمة
غادرة، تتلبسك دون أن تتنبه. أتدري كيف تلبستني؟ أثناء نومي! نعم، أثناء
نومي. لقد كنت أؤدي عملي بنشاط ولم يخطر ببالي البتة أن مثل هذه الأفكار السوداء
تختبئ في عقلي الباطن. ثم بدأت بعد ذلك أتكلم وأنا نائم. أَوَتدري ماذا سمعوني
أقول؟»
وخفض صوته كشخص مضطر لدواعٍ طبية أن يتلفظ
بكلمات بذيئة.
«لقد سمعوني أقول: ليسقط الأخ الكبير! نعم
هذا هو ما قلته. ويبدو أنني أخذت في ترديده المرة تلو الأخرى، ولا أخفي عليك أنني
مسرور من أنهم قد قبضوا عليّ قبل أن أذهب لأبعد من ذلك. هل تعلم ماذا أنوي قوله
حينما أمثل بين يدي المحكمة؟ سأقول لهم: شكراً، شكراً لأنكم أنقذتموني قبل فوات
الأوان».
فسأله ونستون: «لكن من الذي وشى بك؟»
فأجاب بارصون بنبرة حزينة مفعمة بالفخر:
«إنها ابنتي الصغيرة، لقد كانت تسترق السمع من ثقب الباب وسمدت ما كنت أهذي به،
وفي اليوم التالي بادرت لإبلاغ الدورية. إنها طفلة متقدة الذكاء رغم أنها لم
تتجاوز السابعة. إنني لا أكنّ لها أي ضغينة جراء ذلك، بل على العكس إنني فخور بها
لأن ذلك يعني أنني قد ربيتها تربية قويمة وغرست فيها روح الولاء».
ثم صدرت عنه بعض الاختلاجات المضطربة، فتارة
يقف وأخرى يجلس وهو يمد بصره نحو المرحاض، ثم فجأة خلع سرواله وهو يقول:
- معذرة أيها العجوز إذ لم أعد أحتمل
الانتظار أكثر من ذلك!
وألقى بمؤخرته الكبيرة فوق قاعدة المرحاض،
فغطى ونستون وجهه بيديه إلا أن صوتاً عالياً انبعث من شاشة الرصد: سميث، ونستون
سميث 6079، اكشف عن وجهك، فذلك غير مسموح به في الزنزانة. فكشف ونستون عن وجهه،
لكنه تبين بعدما انتهى بارصون من استعمال المرحاض وبصورة فجة تثير الاشمئزاز أن
سدادة البالوعة لا تعمل ما جعل الزنزانة تغص برائحة بغيضة ونتنة لساعات.
وأخيراً ذهب بارصون، فكثير من السجناء يجيئون
ويذهبون دون أن يعلم أحد بما آل إليه مصيرهم، ومنهم امرأة ارتعدت فرائسها وامتقع
لونها بمجرد أن سمعت الضابط يأمرها أن تذهب إلى الغرفة 101. وكان ونستون قد فقد
الإحساس بالوقت ولم يعد يميز الليل من النهار. أما عن السجناء الآخرين فكانت
الزنزانة تضم ستة موقوفين من الرجال والنساء، يجلسون بلا حراك وقد خيم عليهم
جميعاً صمت مطبق. وقبالة ونستون كان يجلس رجل أشبه بحيوان مجتر ذي أسنان بارزة
وذقن جرداء، كما كانت له أوداج منتفخة تبعث على الاعتقاد بأنه يختزن بعض الطعام في
فمه، وكان ينتقل بعينيه خلسة من سجين إلى آخر حتى إذا ما التقت عيناه بعيني أحدهم
أشاح بوجهه سريعاً.
وفُتح الباب مرة أخرى ليزج بسجين آخر إلى
الزنزانة. وكانت هيئته تقشعر لها الأبدان. كان رجلاً عادياً ذا هيئة مزرية ولعله
كان مهندساً أو فنياً من نوع ما، لكن الشيء الذي راع ونستون فيه هو وجهه الناحل
الذي كان أشبه بالجمجمة. وبسبب نحافته كان فمه وعيناه يبدوان أوسع مما هما في
الواقع وبصورة مشوهة، كما كانت نظراته تنطوي على غدر وكراهية متأججة يضمرها لشخص
أو شيء ما.
جلس الرجل فوق المقعد على مقربة من ونستون،
لكن ونستون لم يتطلع إلى وجهه ثانية وإن كان وجهه المعذب الأشبه بالجمجمة قد انطبع
في مخيلته وكأنه يقف أمام عينيه مباشرة. وفجأة أدرك ونستون السر وراء هذا النحول،
لقد كان الرجل يتضور جوعاً. ويبدو أن جميع سجناء الزنزانة قد فطنوا إلى ذلك في الوقت
نفسه. وبدت علامات التململ على كل الجالسين فوق المقعد الخشبي، وظل الرجل ذو الذقن
الجرداء يحملق في صاحب الوجه الأشبه بالجمجمة ثم لا يلبث أن يجفل مبتعداً عنه ثم
يقترب منه ثانية تحت تأثير جاذبية لا تقاوم ثم يبتعد عنه مرة أخرى وقد تلبسه شعور
بالذنب ولذلك فقد راح يتململ في جلسته. وأخيراً هبّ واقفاً وراح يمشي داخل
الزنزانة بخطى مضطربة، ودس يده في جيبه ليخرج كسرة خبز قدمها على الفور إلى الرجل
ذي الوجه الأشبه بالجمجمة وعلامات الارتباك واضحة عليه.
وعلى الفور انطلق زئير غاضب من شاشة الرصد
يصم الآذان، فقفز الرجل ذو الأوداج المنتفخة والذقن الجرداء عائداً إلى مكانه في
حين كان الرجل ذو الوجه الأشبه بالجمجمة قد سحب يده وراء ظهره وكأنه يريد أن يُري
العالم كله أنه قد رفض الهدية.
فزأر الصوت: (بامستيد! بامستيد رقم 2713 دع
كسرة الخبز تسقط على الأرض».
فأذعن الرجل للأمر وترك كسرة الخبز تسقط على
الأرض. وصاح الصوت من الشاشة ثانية: «اثبت مكانك، وانظر نحو الباب ولا تأتِ
بحركة».
وانصاع الرجل للأمر ثانية فيما كانت أوداجه
ترتجف من الفزع. وفتح الباب وما إن دخل الضابط الشاب وانتحى جانباً حتى ظهر من
ورائه حارس مكتنز القامة مفتول الذراعين عريض المنكبين. ووقف الحارس قبالة السجين
ذي الوجه الأشبه بالجمجمة وما إن صدرت له الإشارة من الضابط حتى سدد لكمة، جمع
فيها كل ما أوتي من عزم، لفم السجين، وكانت اللكمة من القوة بحيث طرحته أرضاً فسقط
عند قاعدة المرحاض. وظل ممدداً لبضع لحظات فاقداً الوعي بينما كان فمه وأنفه
ينزفان دماً داكناً. ولم يصدر عنه غير أنين أو صرير خافت بدا أنه لا يشعر بهما. ثم
تدحرج حتى رفع نفسه عن الأرض وهو يترنح مستعيناً بيديه وركبتيه. ووسط دمه النازف
ولعابه السائل رأى ونستون فكّي الرجل يرتطمان بالأرض.
وتسمّر السجناء الآخرون في الأرض وقد عقدوا
أيديهم فوق ركبهم، وعاد الرجل ذو الأوداج المنتفخة إلى مكانه وقد تورم والتهب أحد
صدغيه حتى أصبح أشبه بكتلة هلامية بلون الكرز مع فتحة سوداء في منتصفها. ومن حين
لآخر كان الدم يقطر فوق سترته، بينما ظل ينقل عينيه الرماديتين بين وجوه السجناء
يخامره شعور بالذنب أقوى من ذي قبل وكأنما كان يحاول أن يستشف مدى ازدراء الآخرين
له بعد ما لحق به من إذلال جزاء فعلته.
وفُتح الباب من جديد، وأشار الضابط الشاب
إشارة صغيرة إلى السجين ذي الوجه الأشبه بالجمجمة قائلاً؟
- إلى الغرفة 101.
وصدرت عن ونستون شهقة وبدا عليه الاضطراب.
وكان السجين قد خرّ راكعاً على ركبتيه ولداه مضمومتان إلى صدره وراح يصرخ متضرعا:
أيها الرفيق! أيها الضابط! أضرع إليك ألا
تأخذني إلى ذلك المكان. لقد اعترفت لكم بكل شيء، ماذا تريدون بعد؟ لم يعد لدي ما
أعترف به. قل لي بماذا تريدونني أن أعترف وأنا مستعد للاعتراف فوراً، أو اكتب
الاعتراف وسأوقع عليه في الحال! على أي شيء. لكن لا تذهبوا بي إلى الغرفة 101.
فعاد الضابط يكرر: «جرّوه إلى الغرفة 101».
ولاحظ ونستون أن وجه الرجل الذي كان شاحباً
بالفعل قد انقلب وعلى نحو لا يصدق إلى اللون الأخضر.
وراح السجين يصيح متضرعاً: «افعلوا بي ما
شئتم! لقد جوعتموني لأسابيع طويلة، اقتلوني. أطلقوا عليّ الرصاص. اشنقوني. اقضوا
عليّ بالسجن خمساً وعشرين سنة. هل من أحد تريدون أن أشي به؟ فقط أشيروا لي من
يكون، فأنا لا أبالي بمن سيكون هذا الشخص ولا بما ستفعلون به. إن لي زوجة وثلاثة
أطفال أكبرهم لم يتجاوز السادسة، فلتذبحوهم أمام عيني وسأقف متفرجاً على ذلك، لكن
لا تذهبوا بي إلى الغرفة 101!
فعاد الضابط يقول: «إلى الغرفة 101».
وتطلّع الرجل حواليه في جنون إلى بقية
السجناء، وكأنه يود أن يختار ضحية أخرى بدلاً منه، واستقرت عيناه على الرجل ذي
الأوداج المنتفخة ومد ذراعه المنحولة صائحاً:
«هذا هو الرجل الذي ينبغي أن تأخذوه! إنكم لم
تسمعوا ما كان يقوله بعدما هشمت اللكمة أسنانه. امنحوني الفرصة وسأخبركم بكل كلمة
نطق بها. إنه هو من يعادي الحزب ولست أنا». وتقدم الحارسان نحوه فتعالى صوته حتى
صار أشبه بالعويل: «إنكم لم تسمعوا ما قاله، لقد لحق الصمم بشاشة الرصد آنذاك. إنه
الرجل الذي يهمّكم، خذوه هو، ودعوني أنا!»
انحنى الحارسان ليجراه من ذراعيه، ولكنه كان
في تلك اللحظة قد انبطح أرضاً وقبض بيديه على أحد القوائم الحديدية التي يرتكز
عليها مقعد الزنزانة وراح يعوي كحيوان. أمسك به الحارسان لفك قبضته عن القائم
الحديدي، لكنه كان يتشبث بقوة مذهلة. أما السجناء الآخرون فكانوا يجلسون في صمت
وذعر وقد عقدوا أيديهم حول ركبهم وهم ينظرون شاخصين أمامهم. وتوقف العواء والعويل،
ولم يعد لديه طاقة إلا على التشبث بالقائم الحديدي. وحينئذ دوت صرخة من نوع مختلف،
لقد حطمت ضربة من حذاء أحد الحارسين أصابع إحدى يديه وبعدئذ أوقفاه على قدميه
وراحا يجرجرانه إلى الخارج.
فقال الضابط: «إلى الغرفة 101».
وسار الرجل معهم وهو يترنح منكفئ الرأس ويمسك
بيده المسحوقة وقد خارت جميع قواه.
مرّ وقت طويل، فاذا كان الوقت ليلاً حينما
أخذوا صاحب الوجه الأشبه بالجمجمة، فقد غدا الوقت صباحا، ولو أنه كان صباحاً،
لأضحى ظهراً. وبات ونستون وحيداً لساعات بعدما كان جميع السجناء قد غادروا
الزنزانة. وكان الجلوس على المقعد الضيق يسبب له ألماً فكان ينهض من مكانه فيروح
ويجيء في الزنزانة دون أن يسمع نهياً عن ذلك من الشاشة.
وكانت كسرة الخبز ما زالت حيث رمى بها الرجل
ذو الأوداج المنتفخة. في البداية راودته نفسه أن يلتقطها لكنه كان يقاوم ذلك، أما
الأن فقد عافها بعد أن اشتد عليه العطش وصار فمه لزجاً ونتن الرائحة. وكان صوت
الطنين المستمر والضوء الأبيض الذي لا ينطفئ قد أصاباه بدوار نجم عن إحساسه بأن
رأسه قد أصبح مجوفاً. وكان ينهض على قدميه كلما اشتد عليه ألم عظامه ثم لا يلبث أن
يعاود الجلوس في الحال لأن الدوار كان يجعله غير واثق مما إذا كانت قدماه ستحملانه
أم لا. وكان الذعر يستحوذ عليه كلما أمكنه السيطرة على إحساساته الجسدية، أما
حينما يفكر في أوبراين وفي شفرة الحلاقة فكان يداعبه بصيص من الأمل. كان يعتقد أن
الشفرة ربما تُهرّب إليه مخبأة في الطعام إن كانوا سيقدمون له طعاماً. ولم يكن
يفكر في جوليا إلا عرضاً، فلا بد أنها تتعذب في مكان ما، وربما كان عذابها يفوق
عذابه، بل لعلها تصرخ من الألم المبرح الذي يحيق بها في هذه اللحظة. وقال في نفسه:
ترى لو أن مضاعفة ألمي كان فيها إنقاذا لجوليا، هل كنت أقبل بذلك؟ أجل كنت أقبل.
لكن ذلك كان مجرد قرار صوري اتخذه لعلمه أن عليه أن يتخذه. لكنه لم يكن يحس به في
قرارة نفسه. ففي هذا المقام لا يملك المرء أن يشعر بشيء سوى الألم أو انتظار
الألم. ثم هل من الممكن حينما يكون المرء يتعذب فعلا أن يرغب، لأي سبب من الأسباب،
في أن يزاد له في ألمه؟ لكنه لم يكن قد توصل إلى إجابة عن هذا السؤال بعد.
ومرة أخرى تناهت إلى سمعه وقع أقدام الحرس
تقترب من الزنزانة. وفتح الباب، ودخل أوبراين.
وما إن رآه ونستون حتى هبّ واقفاً على قدميه.
وكان وقع المفاجأة شديدا حتى أنه نسي كل حذر من شاشة الرصد بل نسي وجودها بالمرة
وصاح:
- حتى أنت وقعت في قبضتهم أيضاً!
فقال أوبراين بشيء من التهكم: «لقد وقعت في
قبضتهم منذ أمد طويل». وانتحى جانباً ليظهر خلفه حارس عريض المنكبين يمسك بهراوة
طويلة سوداء في يده.
وقال أوبراين: «لقد كنت تعرف ما سيؤول إليه
أمرك، فلا تخدع نفسك. لقد كنت دائماً تعرف ذلك».
لقد أدرك ونستون كل شيء الآن. لكن لم يعد ثمة
فائدة ترجى من التفكير في ذلك. وفي هذه اللحظات لم يكن يرى من العالم إلا الهراوة
التي بيد الحارس الذي قد يهوي بها على أي مكان في جسمه، على رأسه، أو صوان أذنه،
أو على ذراعه، أو على مرفقه.
لكنه هوى بها على المرفق! فخر ونستون أرضاً
على ركبتيه وكاد يفقد صوابه، وقد أمسك مرفقه بيده الأخرى، وتحول كل شيء في عينيه
إلى اللون الأصفر. ولم يصدق أن ضربة واحدة يمكن أن تسبب له كل هذا الألم المبرح.
أفاق قليلاً من الضربة فلاحظ أن الرجلين ينظران إليه بازدراء، وكان الحارس يضحك من
جسده المتلوي. وهنا حضره الجواب عن ذلك السؤال وهو أن المرء لا يمكن أبداً ومهما
كانت الأسباب أن يرغب في زيادة ألمه. فإزاء الألم لا يمكن للإنسان إلا أن يرغب في
توقفه. فليس في العالم ما هو أسوأ من الألم الجسدي، وحيال الألم ليس هناك أبطال،
ليس هناك أبطال. وظلت هذه الفكرة تدور في رأسه بينما كان يسقط أرضاً وهو يتلوى
ألماً ويشدّ على ذراعه اليسرى التي جعلتها الضربة عاجزة.
وجد ونستون نفسه ممدداً فوق سرير يشبه أسرة
المعسكرات، عدا أته كان أكثر ارتفاعاً عن الأرض وكان مقيّد الأطراف بحيث لا يستطيع
حراكاً، والضوء الأكثر سطوعاً من المعتاد يسقط على وجهه مباشرة. وكان أوبراين يقف
إلى جانبه متفرّساً في وجهه، وإلى الجانب الآخر كان يقف رجل يرتدي معطفاً أبيض
اللون ويحمل في يده محقنة.
وحتى بعد أن فتح ونستون عينيه لم يعي ما حوله
إلا تدريجياً. كان يحس وكأنه يسبح صاعداً إلى فضاء هذه الغرفة قادما من عالم آخر،
من أعماق مياه سحيقة تحتها، أما كم من الوقت مرّ عليه فذلك أمر يجهله تماماً، فمذ
ألقوا القبض عليه لم يعد يرى ظلمة الليل ولا ضوء النهار. وفوق ذلك كله كان انسياب
ذاكرته متقطعاً، فقد مرت عليه أوقات كان وعيه يصاب بالشلل التام، بما في ذلك الوعي
الذي قد ينتاب المرء في نومه، ثم يدب فيه الوعي من جديد بعد فاصل زمني ما. ولكن هل
كان هذا الفاصل يمتد لأيام أم لأسابيع أم لمجرد ثوان فهذا أمر لم يكن من سبيل
لمعرفته.
كانت تلك الضربة التي تلقاها فوق مرفقه إيذاناً
ببداية الكابوس الذي سيخوض غماره، وقد أدرك فيما بعد أن كل ما مرّ به حتى تلك
الضربة لم يكن إلا استجواباً اعتيادياً وتمهيدياً يخضع له كل السجناء تقريباً، إذ
هنالك سلسلة طويلة من جرائم التجسس والتخريب وما شاكلها لا يمكن لأحد إلا ّأن
يعترف بها كأمر واقع. ورغم أن هذه الاعترافات لم تكن إلا إجراء شكلياً، فإن
التعذيب الذي كان يترافق معها كان أمراً لا يدمنه، ولم يكن ونستون بمقدوره أن
يتذكر كم مرة تعرّض للضرب ولا كم من الزمن استغرقت هذه العملية، فكل ما يذكره هو
أنه كان هنالك دائماً خمسة أو ستة رجال يلبسون زياً أسود اللون ويحيطون به. أحيانا
ينهالون عليه ضرباً بقبضات أيديهم أو بهراوات غليظة وأحياناً أخرى بعصي فولاذية أو
ركلاً بأحذيتهم الثقيلة.
وكانت تمر عليه أوقات يتدحرج فيها على الأرض
وكأنه حيوان مخز، يتلوى بجسده محاولاً دون جدوى تجنّب الضربات، لكن ذلك كان يدفعهم
لمزيد من الضرب على ضلوعه وبطنه ومرفقيه وساقيه وخصيتيه وعموده الفقري، وفي بعض
الأحيان كانت هذه العملية تتواصل حتى يخيل إليه أن ما يؤلمه ليس ضربات الحراس
وإنما عجزه عن أن يفقد وعيه. أما في أحيان أخرى فكانت شجاعته تخذله فينخرط في
البكاء طالباً الرحمة، حتى قبل أن يبدأ الضرب، حيث كانت مجرد رؤيته لقبضة أحد
الحراس وهي تتأهب للكمه كفيلة بأن تجعله يعترف بجرائم حقيقية وأخرى خيالية، كما
مرت عليه أوقات كان يعقد العزم على عدم الاعتراف بشيء، وحينئذ كانت كل كلمة تنتزع
منه ممزوجة بالألم والضنى، وفي أوقات أخرى كان يتخلى تحت تأثير الضربات عن عزمه
ذلك وهو يقول في نفسه: لسوف أعترف ولكن ليس الأن، يجب أن أصمد في وجه الألم حتى
يبلغ درجة لا تطاق، ثلاث ضربات أخرى، ضربتان أخريان وسوف أعترف لهم بكل ما يريدون.
وأحياناً كان يُضرب حتى تعجز ساقاه عن حمله، فيرتمي فوق أرضية الزنزانة ككيس من البطاطس،
ثم يُترك لبضع ساعات حتى يتعافى من آثار الضرب، ليعودوا إلى تعذيبه من جديد. وكان
هنالك أيضاً فترات نقاهة أطول، لكنه لم يكن يذكرها إلا على نحو غامض لأنه كان يمضي
جلها إما نائما وإما فاقداً للوعي، فهو يذكر زنزانة لا تضم سوى سرير خشبي ورف بارز
من أحد حوائطها وحوض غسيل من القصدير ووجبات من الحساء والخبز مصحوبة أحياناً
بالقهوة، ويذكر أن حلاقاً فظاً قد جيء به ليحلق له شعره ودقنه، وأن رجالاً بثياب
بيضٍ غلاظ القلوب كانوا يجسون نبضه ويفحصون أعصابه ويفتحون عينيه ويمررون أصابعهم
الخشنة فوق جسده بحثا عن كسور في عظامه ثم يغرزون بعض الإبر في جلده لينام.
وبعد ذلك قلّت وتيرة عمليات التعذيب التي
يخضع لها حتى باتت مصدر تهديد أو رعب يتوعده المحققون بإعادته إليه في أي لحظة لا
تروقهم أجوبته. ولم يعد المحققون هؤلاء الرجال المتوحشين بثيابهم السوداء، وإنما
أصبحوا رجالاً من مثقفي الحزب، وهم رجال ضئيلو الأجسام سريعو الحركة وذوو نظارات
لامعة كانوا يتناوبون العمل عليه فيمتد استجوابهم لهم في النوبة الواحدة عشر أو
اثنتي عشرة ساعة. وكان هؤلاء المحققون الأخيرون يعرّضونه لألم خفيف متواصل لأنهم
لم يكونوا يعتمدون الألم وسيلة رئيسية لانتزاع الاعترافات. فكانوا يصفعونه على
وجهه ويلوون أذنيه ويشدون شعره ويرغمونه على الوقوف على ساق واحدة ولا يسمحون له
بقضاء حاجته ويسلطون أضواء قوية على عينيه حتى تجري بالدموع، لكن هدفهم من كل ذلك
لم يكن إلا إذلاله وتحطيم قدرته على الحجاج والجدال. وكان سلاحهم الفعلي الاستجواب
المتواصل الذي لا رحمة فيه ولا هوادة حيث كانوا يبدلون أقواله عن مواضعها
ويحورونها تحويراً وينصبون له الشراك في كل سؤال ولمسكون عليه كل ما يظهر أنه
أكاذيب أو تناقضات في أقواله حتى أنه كان يجهش بالبكاء من شعوره بالخزي كلما من
شعوره بالإجهاد العصبي. وأحياناً كان يبكي عشرات المرات في جلسة التحقيق الواحدة،
وفي معظم الأوقات كانوا يشتمونه بأقذع الكلمات ويهددونه في كل مرة تبدو عليه
علامات التلكؤ في الإجابة، بأنهم سيسلمونه إلى الحراس مرة ثانية، لكنهم كانوا في
أحيان أخرى يغيرون لهجتهم فجأة وينادونه بالرفيق ويناشدونه باسم الاشتراكية
الإنجليزية والأخ الكبير ويسألونه والأسف باد على وجوههم عما إذا كان لديه من
الولاء للحزب ما يكفي لجعله يتوب عما بدر عنه من آثام إزاء الحزب. وحينما كانت
أعصابه تنهار وتصبح كخرقة بالية إثر ساعات طويلة من التحقيق، كان مجرد مناشدتهم له
بمثل هذه الكلمات تجعله يجهش ببكاء حار تمتزج فيه دموعه بمخاط أنفه. وفي النهاية
كانت هذه الأصوات المناكدة تفضي به إلى انهيار تام لا يبلغه تحت تأثير ركل أحذية
الحراس وقبضاتهم، فكانت تخور كل قواه ويصبح مجرد فم ينطق ويد توقّع على أي شيء
يطلب منه، وغدا همه الوحيد آنذاك أن يكتشف ما يريدون منه أن يعترف به حتى يبادر
إلى الاعتراف قبل أن يلجأ المحققون لحمله على ذلك، وقد اعترف باغتيال عدد من أعضاء
الحزب البارزين وتوزيع منشورات تحرض على الفتنة واختلاس أموال عامة وبيع أسرار
عسكرية واعترف بالاشتراك في عمليات التخريب بشتى أنواعها، وبأنه كان عميلاً
مأجوراً لحكومة إيستاسيا منذ عام 1968، وبأنه كان مؤمناً بالله ومعجباً
بالرأسمالية وبأنه قد انزلق إلى الشذوذ الجنسي، وأقر كذلك بقتل زوجته، بالرغم من
أنه يعرف، مثلما يعرف المحققون، أن زوجته لا تزال على قيد الحياة. واعترف أيضاً بأنه
ظل لسنوات على اتصال شخصي مع غولدشتاين وبأنه كان عضواً بمنظمة سرية تضم كل
الأشخاص الذين يعرفهم. لقد كان من الأسهل عليه أن يعترف بكل شيء وأن يورط كل شخص
يعرفه، أضف إلى ذلك أن ما قاله كان صحيحاً من زاوية ما، فقد كان معادياً للحزب ومن
وجهة نظر الحزب لا فرق بين التفكير في الإثم وبين اقترافه.
وكانت لديه كذلك ذكريات من لون آخر تبرز أمام
مخيلته بشكل متقطع كصور يجللها السواد من كل ناحية، فيذكر أنه كان قابعاً في
زنزانة لا يعرف إن كانت مظلمة أو مضيئة لأنه لم يكن يستطيع أن يميز فيها شيئاً غير
زوجين من العيون وعلى مقربة منه كانت هنالك آلة تدق دقات بطيئة ومنتظمة وكانت
العينان تتسعان وتزدادان بريقاً، وفجأة أحس بأنه طار من مقعده وغطس في هاتين
العينين اللتين ابتلعتاه.
ثم أحس أنه شدّ إلى مقعد تحيط به ساعات وتسلط
عليه أضواء باهرة تزيغ الأبصار، وإلى جواره كان يقف رجل يرتدي معطفاً أبيض اللون
ويقرأ ما تشير إليه الساعات، ثم سمع وقع أقدام ثقيلة خارج الغرفة، وفتح الباب
ليدخل ممه ضابط ذو وجه كالح يتبعه حارسان.
وقال الضابط: «إلى الغرفة رقم 101».
لم يلتفت الرجل ذو المعطف الأبيض، كما لم يعر
ونستون اهتماماً إذ كان كل اهتمامه منصباً على النظر إلى الساعات.
ومن ذكرياته أيضاً أنه كان يتدحرج عبر ممر
طويل فسيح تغمره أضواء باهرة وتتعالى فيه الضحكات، وكان أثناء التعذيب يصيح بأعلى
صوته معترفاً بكل شيء بما في ذلك الأشياء التي كان نجح في إخفائها، كما راح يروي
قصة حياته بكاملها أمام مستمعين كانوا يعرفونها بالفعل، وكان يحيط به الحراس
والمحققون والرجال ذوو المعاطف البيضاء وأوبراين وجوليا والسيد شارنغتون، وجميعاً
يرافقونه عبر الممر وهم يقهقهون. لقد كان ثمة شيء مخيف يحمله له المستقبل، لكن ذلك
الشيء لم يعد له وجود ومن ثم لن يحدث، إذ أصبح كل شيء على ما يرام فلم يعد هناك
مزيد من الألم بعد أن كشف لهم كل تفاصيل ودقائق حياته التي فهموها فصفحوا عنه.
وكان يحاول النهوض في سريره الخشبي وهو شبه
متيقن من أنه سمع صوت أوبراين، ومع أنه لم ير أوبراين مطلقاً طوال عملية استجوابه
فقد كان يشعر أن أوبراين قريب جداً منه وإن كان لا يراه. وبالفعل كان أوبراين هو
الذي يوجه كل شيء، كان هو الذي يعين الحراس على ونستون وهو الذي منعهم من قتله،
لقد كان هو صاحب الكلمة فيما يتعلق بمتى يجب أن يصرخ ونستون من فرط الألم ومتى يجب
أن يمنح فترة راحة، ومتى يجب أن يُقدّم له طعام ومتى يجب أن ينام، ومتى يجب أن
يُحْقن بالعقاقير المخدرة، كان هو من يوجه له الأسئلة وهو من يوحي له بالإجابات،
كان المعذب والحامي والمحقق والصديق معاً. وذات مرة سمع ونستون صوتاً، لا يذكر هل
كان أتاه تحت تأثير المخدر أو أثناء نومه الطبيعي أو حتى في لحظة يقظة كاملة،
صوتاً يهمس في أذنه قائلاً: لا تخف يا ونستون فأنت تحت رعايتي، منذ سبع سنوات وأنا
أحيطك برعايتي، والآن حانت اللحظة الحاسمة، سوف أنقذك وسأجعلك نموذجاً يقتدى به.
لم يكن ونستون على يقين من أن صاحب هذا الصوت هو أوبراين، لكن هذا الصوت هو نفسه
الذي سمعه في الحلم منذ سبع سنوات يقول له: سوف نلتقي في مكان لا يحل فيه ظلام.
لم يكن ونستون يستطيع أن يحدد متى تنتهي جلسة
التعذيب أو متى تبدأ، فكل ما يذكره هو أنه كان يمر بفترات من الظلام الدامس يجد
نفسه بعدها في الزنزانة أو في الغرفة حيث يمدد الآن على السرير. كان مستلقياً على
ظهره فوق السرير لا يستطيع حراكاً، وكان جسده مثبتاً عند كل مفصل من مفاصله، بل
حتى رأسه كان مثبتاً. وكان أوبراين يحدّق فيه بنظرة كلها جدية وأسى، فيما كان وجهه
الذي رآه ونستون من أسفل يبدو خشناً وترتسم عليه علامات الإرهاق وتحت عينيه توجد
انتفاخات وفيما بين الأنف والذقن تمتد تجاعيد توحي بالإعياء. كان أوبراين أكبر
سناً مما ظنه ونستون، ربما كان في الثامنة والأربعين أو الخمسين. وتحت يده ذلك
القرص الذي يتصل به ذراع وحوله أرقام.
قال أوبراين: «لقد قلت لك إننا إذا ما
التقينا ثانية فسيكون لقاؤنا هنا».
فأجاب ونستون: «أجل».
ودونما أي إنذار مسبق، وبحركة خفيفة من يد
أوبراين، غمرت موجة من الألم جسد ونستون، كان ألماً مريعاً لأنه لم يكن يفهم ماذا
يجري له ومع ذلك كان يشعر أنه يتعرض لأذى مميت، ولم يكن ونستون يعلم إن كان ذلك
الذي يحدث له حقيقياً أم غير حقيقي، إلا أن جسده كان يتلوّى ليخرج عن شكله المعهود
ومفاصله كانت تتمزق ببطء. ومع أن العرق كان يتفصد من جبينه، فإن أخشى ما كان يخشاه
هو أن ينقصم عموده الفقري، كما كان يصر على أسنانه ويتنفس من أنفه بصعوبة محاولا
التزام الصمت قدر المستطاع.
قال أوبراين وهو يراقب وجهه: «لعلك تخشى أن
يتحطم جزء من جسمك بعد لحظات، ولا بد أن خوفك الأول يتركز على عمودك الفقري
وتتصوّر الفقرات وهي تتفكك وينسكب منها النخاع، إن هذا هو ما تظنه واقعاً، أليس
كذلك يا ونستون؟»
فلم يجب ونستون، لكن أوبراين كان قد سحب
الذراع المتصلة بالقرص للخلف، فانحسرت موجة الألم سريعاً مثلما داهمته سريعا.
قال أوبراين: «تلك كانت أربعين، وفي استطاعتك
أن ترى أن أرقام هذا القرص تصل إلى المئة، ولذلك أرجو منك ألا تنسى أثناء حديثنا
أن بمقدوري أن أنزل بك الألم في اللحظة التي أشاء وبالدرجة التي أشاء، فإذا لجأت
إلى الكذب أو حاولت المراوغة بأي طريقة أو حتى انخفضت درجة ذكائك عن مستواك
المعهود فسوف تصرخ من الألم لحظة يحدث ذلك. هل تفهم ما أقول؟»
فأجاب ونستون: «أجل».
وهنا تغيرت هيئة أوبراين وأصبحت أقل قسوة،
وأعاد تثبيت نظارته بعناية، وخطا خطوة أو خطوتين. وعندما تكلم كان صوته لطيفاً
متأنياً، وكانت هيئته مزيجاً من هيئة الطبيب والمعلم بل ورجل الدين، كان تواقاً
للشرح والإقناع أكثر منه للعقاب.
وقال: «إنني أتجشم مشقة وجهداً معك يا ونستون
لأنك تستحق ذلك. لا بد أنك تعرف تمام المعرفة ما هو نوع علتك، لقد توصلت إلى هذه
المعرفة منذ سنوات ولكنك قاومتها، إنك مشوش الذهن، وتعاني من ضعف بالذاكرة، ولا
تستطيع تذكر الأحداث الحقيقية ومع ذلك توهم نفسك أنك تذكر أحداثاً أخرى رغم أنها
لم تقع البتة. ولحسن حظك فإن هذا المرض يمكن شفاؤه، فأنت لم تحاول شفاء نفسك منه
أبداً لأنك لم تشأ ذلك، بل ولم تبدِ استعداداً لبذل أي جهد في ذلك السبيل، وإنني
على يقين بأنك حتى هذه اللحظة تتشبث بعلتك هذه معتبراً إياها فضيلة. وسأضرب لك
الآن مثلاً: في اللحظة الراهنة مع أي دولة تتحارب أوقيانيا؟»
فأجاب ونستون: «عندما ألقوا القبض علي كانت
أوقيانيا في حالة حرب مع إيستاسيا»
- مع إيستاسيا، حسناً. وقد كانت أوقيانيا في
حالة حرب دائمة مع إيستاسيا، أليس كذلك؟
أخذ ونستون نفساً طويلاً، وفتح فمه ليتكلم
لكنه لم ينطق بشيء. فلم يستطع أن يرفع عينيه عن القرص.
- الحقيقة من فضلك يا ونستون، الحقيقة التي
تؤمن بها، قل لي ما تظن أنك تذكره.
- أذكر أنه قبل أسبوع واحد من القبض علي، لم نكن
في حالة حرب مع إيستاسيا على الإطلاق وإنما كنا في تحالف معها، وأن رحى الحرب كانت
تدور بيننا وبين أوراسيا، وقد دام ذلك أربع سنوات. لكن قبل ذلك...
وهنا استوقفه أوبراين عن متابعة كلامه بإشارة
من يده.
- وإليك مثل آخر، لقد كنت تعيش لسنوات في ظل
وهم جد خطير، لقد كنت تؤمن بأن الرجال الثلاثة وهم جونز وآرنسون وراذرفورد، الذين
كانوا فيما مضى أعضاء بالحزب ثم جرى إعدامهم جزاء الخيانة والأعمال التخريبية التي
اقترفوها بعد إدلائهم باعترافات كاملة، لم يقترفوا أياً من الجرائم التي أدينوا
بها، وكنت تؤمن بأنك وقعت على دليل وثائقي دامغ يثبت أن كل اعترافاتهم كانت غير
حقيقية، وهنالك صورة فوتوغرافية في ذهنك توهمت أنك قد أمسكت بها في يدك. إنها صورة
تشبه هذه.
وأبرز أوبراين بين أصابعه قصاصة جريدة أمام
عيني ونستون لثوان. لقد كانت صورة ولم يساوره أدنى شك حول ماهيتها، كانت نسخة أخرى
من صورة جونز وآرنسون وراذرفورد وهم في فرع الحزب بنيويورك والتي تصادف أن وقعت
بين يديه منذ إحدى عشرة سنة وقام بإحراقها على الفور آنذاك. للحظة واحدة ظلت هذه
الصورة أمام ناظريه، ثم غابت عنه، ولكنه كان قد رآها، رآها لا ريب في ذلك! وقد
حاول يائساً وبجهد مضن أن يرفع النصف الأعلى من جسده، إلا أنه كان أمراً مستحيلاً
أن يتحرك سنتمترًا واحداً في أي اتجاه، وكان قد نسي القرص في تلك اللحظة، وتملكته
رغبة أكيدة في أن يمسك بالصورة بين أصابعه مرة ثانية أو يراها على الأقل.
وصاح بملء صوته: «إنها موجودة!»
فقال أوبراين: «كلا، ليست موجودة».
ثم خطا بضع خطوات وصولاً إلى محرقة الذكريات
التي كانت في الجدار المقابل، ورفع الغطاء ورمى بها من فتحة المحرقة لتبتلعها
ألسنة اللهب فتتلاشى، ثم التفت أوبراين إلى ونستون وقال:
- الآن استحالت رماداً، بل حتى ليست رماداً،
لقد أصبحت ذرات غبار. إنها لم تعد موجودة الأن ولم يحدث أن كان لها وجود على
الإطلاق.
فقال ونستون: «لكنها كانت موجودة! بل لا تزال
موجودة! إنها موجودة في الذاكرة، وأنا أذكرها كما أنك تذكرها».
فقال أوبراين: «إنني لا أذكرها».
وغاص قلب ونستون بين ضلوعه، لقد كانت تلك هي
ازدواجية التفكير التي قرأ عنها، وسرعان ما تملّكه شعور باليأس القاتل، فلو أنه
استطاع أن يستوثق من أن أوبراين يكذب فإنه لم يكن ليكترث بذلك الأمر، بيد أنه كان
من الجائز تماماً أن أوبراين قد نسي الصورة حقيقة. وإذا صح ذلك، فإنه يكون قد نسي
نكرانه لتذكرها، بل ونسي أنه نسي، فكيف إذن يتسنى للمرء التأكد من أن الأمر لا
يعدو كونه مجرد خداع من جانبه؟ ربما يمكن لمثل هذا التشويش أن يحدث حقيقة في
العقل، وكانت هذه الفكرة هي التي قهرته.
كان أوبراين ينظر إليه بإمعان، وكان قد أخذ،
وأكثر من أي وقت مضى، هيئة معلم يتجشم مشقة وهو يعلم طفلاً معانداً لكنه واعد
وذكي.
وقال أوبراين: «يوجد للحزب شعار يتعلق
بالتحكم في الماضي، هل يمكنك أن تقوله من فضلك؟»
فاذعن ونستون وقال ممتثلاً: «إن من يتحكم في
الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي».
فأومأ أوبراين برأسه مؤمنا وقال: (إن من
يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي، هل ترى أن للماضي وجوداً فعليًا؟»
ومرة أخرى شعر ونستون بالعجز يغمره من رأسه
إلى أخمص قدميه، ومد عينيه إلى القرص ولم يكن يدري إن كانت الإجابة بنعم أو لا هي
التي ستخلصه من هذا الألم، بل إنه لم يدر ما هي الإجابة التي يعتقد أنها صحيحة.
ابتسم أوبراين ابتسامة خفيفة وقال: «إنك لست
من علماء الميتافيزيقا يا ونستون، كما أنك حتى هذه اللحظة لم تفكر فيما تعنيه كلمة
الوجود، وحتى أكون أكثر دقة سأقول: هل الماضي موجود كشيء محسوس ويشغل حيزا في
الفراغ؟ هل يوجد في مكان ما، عالم يتألف من أجسام صلبة مثلاً، لا يزال الماضي يحدث
فيه؟»
- كلا.
- إذن أين يوجد الماضي إن كان له وجود في
الأصل؟
- في السجلات حيث يدوّن.
- في السجلات وفي .....؟
- في العقل وفي ذكريات البشر.
- في الذاكرة، حسناً جداً، إننا، أقصد الحزب،
نسيطر على جميع السجلات ونسيطر على جميع الذاكرات، ومن ثم فإننا نتحكم في الماضي،
أليس كذلك؟
وصرخ ونستون مرة أخرى بصوت عال وقد نسي
القرص: «ولكن كيف تستطيعون منع الناس من تذكر الأشياء؟ إنه عمل لا إرادي حتى أن
أحداً لا يمكنه أن يسيطر على ذاكرته، فكيف تستطيعون أنتم السيطرة على الذاكرة؟
إنكم لم تستطيعوا السيطرة على ذاكرتي».
وبدت علامات التجهم على وجه أوبراين مرة أخرى
ووضع يده على القرص وقال:
- بل على العكس، إنك أنت الذي عجزت عن
السيطرة عليها، وهذا هو ما جاء بك إلى هنا، إنك هنا لأنك فشلت في الانصياع وفي فرض
الانضباط الذاتي على نفسك، إنك لم تتقن عملية الخضوع التي هي ثمن التعقل، وإنما
فضلت أن تكون مجنوناً ووضعت نفسك ضمن أقلية مؤلفة من فرد واحد هو أنت. إن الواقع
لا يراه إلا العقل المنضبط يا ونستون، إنك تؤمن بأن الواقع شيء موضوعي خارجي قائم
بذاته، كما تؤمن بأن طبيعة الواقع طبيعة بديهية بذاتها، وعندما تضلل ذاتك وتوهمها
أنك ترى شيئاً ما، فإنك تفترض أن كل الآخرين يرون الشيء ذاته، ولكني أقول لك يا
ونستون إن الواقع ليس له وجود خارجي، إن الواقع موجود في العقل البشري ولا يوجد في
مكان سواه. إنه ليس موجوداً في العقل الفردي الذي هو عرضة للوقوع في الأخطاء، كما
أنه يفنى بفناء صاحبه، إنه لا يوجد إلا في عقل الحزب الذي يتسم بأنه جماعي وخالد.
وما يعتبره الحزب حقيقة فهو الحقيقة التي لا مراء فيها، ومن المستحيل أن ترى
الحقيقة إلا بالنظر من خلال عيني الحزب. تلك هي الحقيقة التي يجب أن تتعلمها من جديد
يا ونستون، وهذا يحتاج منك أن تدمر ذاتك وهو أمر يتطلب قوة الإرادة، يجب أن تذلّ
نفسك وتقهرها حتى يمكنك أن تكون عاقلاً.
وتوقف هنيهة عن الكلام وكأنه يتيح لكلماته
وقتاً كافياً لتستقر في ذهن ونستون.
ثم أردف: «هل تذكر يا ونستون حينما كتبت في
مذكراتك تقول: إن الحرية هي أن تكون حرا في أن تقول إن اثنين واثنين يساويان
أربعة؟»
- فأجاب ونستون: «نعم».
ورفع أوبراين يده اليسرى جاعلاً ظهرها إلى
ونستون ومخفيا الإبهام خلف الأصابع الأربع المرفوعة، وسأل:
- أربعاً.
- وإذا قال الحزب إنها ليست أربعاً بل خمسة
فكم يكون عددها حينئذ؟
- أربعاً.
ولم يكد ونستون يتم هذه الكلمة حتى صرخ من
شدة الألم الذي سرى في أوصاله، وأشارت الإبرة إلى خمس وخمسين، وبدأ العرق يتفصد من
كل أجزاء جسمه وأخذ الهواء يتدفق إلى رئتيه فيخرج أنيناً لم يمنعه حتى اصطكاك
أسنانه، وكان أوبراين يراقبه بينما لا تزال الأصابع الأربع مرفوعة، ثم سحب أوبراين
الذراع فخفّت حدة الألم بعض الشيء.
وسأل: «كم إصبعاً ترى يا ونستون؟»
- أربعاً.
فارتفعت الإبرة إلى الستين.
- كم إصبعاً ترى يا ونستون؟
- أربعاًا أربعاً! ماذا أقول غير ذلك؟
أربعاً.
لا بد أن الإبرة قد ارتفعت مرة أخرى ولكنها
لم تسترع انتباه ونستون الذي كان يستأثر به ذلك الوجه الغليظ الصارم والأصابع
الأربع، كانت الأصابع تنتصب أمام عينيه وكأنها أعمدة ضخمة تهتز وسط جو غائم، لكنها
مع ذلك كانت أربعاً ولا ريب.
- كم إصبعاً يا ونستون؟
- أربعاً! أوقف عني هذا الألم! لماذا تستمر
في تعذيبي؟ أربعاً! أربعاً!
- كم إصبعاً يا ونستون؟
- إذن خمساً! خمساً! خمساً!
- لا يا ونستون هذا لن يفيدك، إنك تكذب لأنك
ما زلت تعتقد أنها أربع. كم إصبعاً ترى من فضلك؟
- أربعاً! خمساً! أربعاً! الرقم الذي تريده.
كل ما أرجوه هو أن توقف الألم.
وفجأة وجد ونستون نفسه جالساً وقد أحاطت ذراع
أوبراين بكتفيه، ربما كان قد فقد الوعي لبضع ثوان، وأما الأحزمة التي تشد جسمه إلى
السرير فقد حلت وشعر بموجة برد قارس تسري في جسده حتى أن أوصاله كانت ترتجف
وأسنانه تصطك ودموعه تنهمر على خديه، فتشبث بأوبراين وكأنه طفل رضيع وقد أراحته كل
الراحة وعلى نحو مستغرب تلك الذراع الثقيلة الملتفة حول كتفيه. كان يخامره شعور
بأن أوبراين هو حاميه، وأن الألم يأتيه من الخارج ومن مصدر آخر غير أوبراين، وأن
أوبراين هو الذي سيخلصه من الألم.
وقال أوبراين بلطف: «إنك بطيء التعلم يا
ونستون».
فقال ونستون وهو ينتحب: «وماذا عساي أن أفعل؟
كيف يمكنني أن أتجنب رؤية ما هو أمام عيني؟ إن اثنين واثنين يساويان أربعة».
فقال أوبراين: «أحياناً يساويان أربعة يا
ونستون، وأحياناً أخرى يساويان خمسة وقد يساويان ثلاثة أيضاً، وفي أحيان أخرى
يساويان أربعة وخمسة وثلاثة في آن معاً. يجب أن تحاول بمزيد من الجدية والجهد،
فليس من السهل أن تصبح سليم العقل».
ومُدد ونستون ثانية على السرير وشُدَّ وثاقه
من جديد، إلا أن الألم كان قد انحسر وذهبت عنه تلك القشعريرة التي سرت في جسده
لتتركه خائرًا ضعيفاً، وأشار أوبراين برأسه إلى الرجل ذي المعطف الأبيض الذي كان
واقفاً لا يحرك ساكناً طوال تلك العملية، فتقدم ذلك الرجل ومال على ونستون يفحص
عينيه ويجس نبضه ووضع أذنه على صدره وطرق على عظامه هنا وهناك ثم أومأ برأسه إلى
أوبراين.
فقال أوبراين: «مرة أخرى».
وتدفق الألم في جسد ونستون من جديد، وكانت
الإبرة قد بلغت الدرجة السبعين أو الخامسة والسبعين، لكنه اغلق عينيه هذه المرة،
إذ كان يشعر أن الأصابع لا تزال منتصبة وأنها لا تزال أربعاً، فقد كان كل همه هو
أن يظل على قيد الحياة إلى أن تنقشع هذه النوبة من الألم، فلم يعد يعرف إن كان
يصرخ من الألم أو أنه يتألم في صمت، وفتح ونستون عينيه بعدما خفّت حدة الألم مرة
أخرى، حيث كان أوبراين قد سحب الذراع للخلف.
- كم إصبعاً ترى يا ونستون؟
- أربعاً، أظن أنها أربعاً، سأحاول أن أراها
خمساً إن استطعت، إنني أحاول فعلا أن أراها خمساً.
- أترغب يا ونستون أن تقنعني بأنك تراها
خمساً أم أنك تراها فعلاً خمساً؟
- أرغب أن أراها فعلا خمساً.
فقال أوبراين: «إذن مرة أخرى».
ولعل الإبرة أشارت في هذه المرة إلى الثمانين
أو التسعين درجة، ولم يعد في مستطاع ونستون أن يتذكر سبب هذا الألم. وخيل إليه أن
غابة من الأصابع تتراقص أمام عينيه المشدوهتين ولتداخل بعضها في بعض ويتوارى بعضها
وراء بعض ثم يعود فيظهر، وكان يحاول أن يحصيها دون أن يعرف لماذا، لكنه كان يعرف
أن من المستحيل عليه أن يحصيها، وذلك بسبب الطبيعة الغامضة التي تتلبس الخمسة
والأربعة. وزال عنه الألم مرة أخرى، وما إن فتح عينيه حتى تبين له أنه لا يزال يرى
الشيء نفسه، أصابع لا حصر لها ولا عد مثل أشجار متحركة يسير بعضها وراء بعض في
وجهتين متداخلتين، فسارع بإغلاق عينيه مرة أخرى.
- كم إصبعاً ترى يا ونستون؟
- لست أدري، لست أدري. أخاف أن تقتلني إن
فعلت ذلك مرة أخرى. أربعاً، خمساً، ستاً، أقسم لك إنني لست أدري.
فقال أوبراين: «هذا أفضل».
وغُرست إبرة في ذراع ونستون فشعر معها بدفء
مريح يدب في أوصاله حتى كاد ينسى الألم، ففتح عينيه ونظر بعين الرضا والامتنان إلى
أوبراين. وما إن رأى ذلك الوجه الغليظ القميء شديد الذكاء الذي يمتلئ بالتغضّنات
حتى شعر بقلبه يخفق، ولو كان في مستطاعه أن يتحرك لمد يده وتشبث بذراع أوبراين.
لقد أحبه في هذه اللحظة كما لم يحبّه من قبل، ولم يكن ذلك لأنه أوقف الألم فحسب،
وإنما لأن مشاعره القديمة، التي كان يكنها لأوبراين بقطع النظر عما إذا كان صديقاً
أو عدواً، قد جاشت في صدره من جديد، فأوبراين هو الشخص الذي يمكنه أن يتكلم إليه،
ولعل المرء لا يهمه أن يحبه الناس بقدر ما يهمه أن يفهموه، نعم إن أوبراين قد ذهب
في تعذيبه إلى حمد الجنون، بل ومنذ لحظات كان موقناً بأن أوبراين سيرسله إلى مثواه
الأخير، لكن كل ذلك لا يهم، فقد كان يجمع بينهما ما هو أعمق من الصداقة، إنها
الحميمية، وبالرغم من أنهما لا يمكنهما تبادل الحديث معاً، فلا بد أن يأتي يوم
يلتقيان فيه ويتحدثان معا كما يشاءان، ولاحظ ونستون أن أوبراين ينظر إليه نظرة
استوحى منها أن الأفكار نفسها تدور بخاطره، وعندما تكلم أوبراين كانت نبرة حديثه
يسيرة ومفعمة بروح الحوار، فقال:
- أتدري أين أنت يا ونستون الآن؟
- لست أدري، لكن يمكنني التخمين، لعلي في
وزارة الحب.
- هل تعلم كم من الوقت مضى عليك ها هنا؟
- لست أدري، قد تكون أياماً أو أسابيع أو
شهوراً، لكني أعتقد أنني أمضيت شهوراً.
- ولماذا نأتي بالناس إلى هذا المكان حسب
تصورك؟
- كي تجعلوهم يعترفون.
- كلا، ليس هذا هو السبب، حاول مرة ثانية.
- كي تعاقبوهم.
فصرخ فيه أوبراين: «كلا!» وتغيرت نبرة صوته
تماماً وارتسمت على وجهه علامات التجهم والشدة ثم قال:
- كلا، إننا لا نأتي بأحد إلى هنا كي ننتزع
منه اعترافاً أو ننزل به عقاباً. هل تود أن تعرف لماذا أتينا بك إلى هنا؟ لمداواة
علتك! لنجعلك سليم العقل! هلا فهمت يا ونستون، فما من أحد نأتي به إلى هنا ويخرج
قبل أن يبرأ من علته؟ إننا لا نكترث للجرائم الحمقاء التي اقترفتها، فالحزب لا
يهمّه ما تأتيه من أفعال مكشوفة، إنّما يهمّه أكثر ما يدور في رأسك من أفكار، نحن
لا نحطم أعداءنا فحسب، وإنما نغير ما بأنفسهم. هل تفهم ماذا أقصد بذلك؟
كان أوبراين منكفئاً فوق ونستون وقد بدا وجهه
ضخماً لشدة قربه منه، وبشعاً قبيحاً لأن ونستون يتطلع إليه من أسفل، كما أنه كان
يبدو مفعماً بالنشاط والتوتر الطائش. ومرة أخرى خفق قلب ونستون، ولو أن الأمر بيده
لكان قد غاص في السرير أكثر، فقد تأكد له أن أوبراين يوشك أن يدير القرص مدفوعاً
بوحشية مفرطة، إلا أن أوبراين استدار مبتعداً في هذه اللحظة وأخذ يذرع الغرفة جيئة
وذهاباً مرة أو مرتين. ثم تابع حديثه وقد فتر حماسه:
- إن أول ما يتوجب عليك فهمه هو أننا لا نسمح
لأحد بأن يخرج من هذا المكان شهيداً، لا بد أنك قرأت عن الاضطهاد الديني في الماضي
والذي مورس في العصور الوسطى تحت ما يسمى بمحاكم التفتيش التي فشلت فشلاً ذريعاً،
لقد أنشئت تلك المحاكم لاستئصال شأفة الهرطقة، لكنها على العكس كرست وجودها. ففي
مقابل كل هرطوقي يُحرق بعد شدّه على الخازوق كان يظهر الآلاف غيره. فما السبب يا
ترى؟ السبب هو أن محاكم التفتيش كانت تقتل أعداءها جهاراً نهاراً وتجهز عليهم قبل
أن يتوبوا، وفي الواقع لقد كانوا يُحرقون لأنهم لم يظهروا ندامتهم أو يعلنوا
توبتهم، ومن ثم كان الناس يُحرقون لأنهم يرفضون التخلي عن معتقداتهم الصحيحة،
وبالطبع كان المجد كله يؤول إلى الضحية، بينما يبقى كل الخزي من نصيب المحقق.
وفيما بعد في القرن العشرين، ظهر ما يسمى بالحكم الاستبدادي، فكان هناك النازيون
الألمان والشيوعيون الروس الذين كان سجلهم في اضطهاد مناوئيهم حافلاً بقسوة تفوق
ما اقترفته محاكم التفتيش. ومع ذلك كانوا يظنون أنهم تعلموا من أخطاء الماضي، فقد
كانوا على أي حال يدركون أنه ينبغي عليهم ألا يجعلوا من خصومهم شهداء. ولذلك كانوا
لا يقدمون ضحاياهم للمحاكمات العلنية إلا بعد أن يستوثقوا من تحطيم كرامتهم
وإذلالهم، إذ كانوا ينهكون قواهم بالتعذيب ويعزلونهم عن العالم حتى يتحولوا إلى
مسوخ ذليلة وحقيرة ويعترفون بكل ما يوضع على ألسنتهم ويصمون أنفسهم بالخزي والعار،
ويتهم بعضهم بعضاً ويتضرعون طلبا للرحمة. ومع كل ذلك لم تكن تمر سوى بضع سنوات حتى
يتكرر الشيء نفسه ثانية، إذ يتحول الموتى إلى شهداء بينما يُنسى ما لحق بهم من ذل
وهوان. والسؤال: لماذا حدث هذا؟ والجواب هو: أولاً، لأن الاعترافات التي يدلون بها
كانت كاذبة وتنتزع منهم قسراً، أما نحن فلا نقترف مثل هذه الأخطاء. فكل الاعترافات
التي تجري هنا صحيحة، إننا نجعلها كذلك، وفضلاً عن كل ذلك نحن لا نسمح للموتى أن
يبعثوا من قبورهم ليناهضونا، ولذلك يجب عليك أن تكف عن التوهم بأن الأجيال القادمة
ستبرئ ساحتك وتجعل منك شهيداً، إنهم لن يسمعوا عنك أبداً لأنك ستُزال تماماً من سجل
التاريخ، سنحيلك إلى غاز ثم نطلقك في الهواء، سنجعلك نسياً منسياً ولن يبقى منك
شيء، لا اسما في سجل ولا أثرا في ذاكرة حية، ستمحى كل علاقة لك بالماضي كما
بالمستقبل وستصبح وكأنك لم تكن.
وتساءل ونستون في نفسه بمرارة: إذن علام كل
هذا التعذيب؟
وتوقف أوبراين عن السير في الغرفة، وكأنه
يسمع تساؤل ونستون، فأصبح وجهه الدميم أكثر قرباً وضاقت عيناه أكثر.
وقال له: لعلك تتساءل لماذا نتجشم مشقة
استجوابك؟ ما دمنا ننوي القضاء عليك قضاء مبرماً وما دام لا شيء مما تقوله أو
تفعله يمكن أن يغير من الأمر شيئا، إن هذا هو التساؤل الذي يدور بخاطرك، أليس
كذلك؟»
فأجاب ونستون: «نعم».
فابتسم أوبراين ابتسامة خفيفة وقال: «إنك
العيب الذي شق النموذج العام، إنك الوصمة التي يجب مَحْوها. ألم أقل لك قبل لحظات
إننا نختلف عن طغاة الماضي؟ فنحن لا نقبل بالطاعة السلبية أو حتى بالخضوع، وعندما
تسلم لنا قيادك في النهاية يجب أن يكون ذلك نابعاً من إرادتك الحرة. إننا لا نحطم
الضّال الذي خرج علينا عندما يقاومنا، بل إننا لا نقدم أبداً على تدميره طالما أنه
يقاومنا وإنما نسعى لأن نغيره ونقبض على عقله الباطن فنصوغه في قالب جديد. إننا
نبدد كل ما يضمره من شرور ونخرج كل ما يحمله من أوهام فنردّه إلى صف الحزب ليس في
مظهره فحسب، وإنما أيضاً في جوهره قلباً وقالباً. إننا نجعله واحداً منا قبل أن
نقتله، ذلك أنه مما لا يحتمل بالنسبة إلينا هو أن توجد فكرة خاطئة في أي مكان من
العالم معهما كانت خفية ومعدومة القوة، وحتى في لحظة الموت لا نسمح بأي شكل من
أشكال الانحراف. ففي الأيام الغابرة كان الهراطقة يسيرون نحو الخوازيق المعدة لهم
وهم يجهرون بهرطقاتهم ويتباهون بها، وضحايا حملات التطهير الروسية كانوا يحملون
تمرّدهم داخل رؤوسهم حتى وهم يساقون عبر الممر في انتظار الرصاصة القاتلة. لذلك
فإننا نجري للدماغ غسيلاً شاملاً قبل أن نعصف به، لقد كان طغاة الماضي يأمرون على
النحو التالي: يجب ألا تفعل ذلك، بينما كان الحكام المستبدون يقولون: يجب أن تفعل،
أما نحن فأمرنا يأتي على النحو التالي: كن. ولم يسبق أن جئنا بأحد إلى هذا المكان
ثم وقف ضدنا وناهضنا لأن كل شخص يخضع لغسيل دماغ، بل حتى هؤلاء الخونة الثلاثة
التعساء، جونز وآرنسون وراذرفورد، الذين كنت تؤمن ذات يوم ببراءتهم قد انفرط عقدهم
وخرّ عزمهم في النهاية، لقد أشرفت بنفسي على استجوابهم ورأيتهم وهم ينهارون
تدريجياً وتذللون ويتضرعون وينتحبون، وفي النهاية لم يكن كل هذا مبعثه الخوف أو
الألم بل شعورهم بالندم والأسف على ما اقترفوا. وعندما انتهينا من تطهيرهم كانوا
قد تحولوا إلى هياكل بشرية لم يبق منها إلا الأسى على ما بدر عنها من جرائم في حق
الحزب والحب للأخ الكبير. لقد كان من المؤثر فعلاً أن ترى مبلغ ما أصبحوا عليه من
حب للأخ الكبير حتى أنهم تضرعوا إلينا كي نطلق عليهم الرصاص ليموتوا قبل أن تعلق
بعقولهم التي تطهرّت أي شيء من أدران الماضي».
كان صوت أوبراين قد أصبح هادئاً، ولو أن
الاعتداد بالنفس الذي ظهر في شكل حماس جنوني، ظل يرتسم على وجهه. فقال ونستون
لنفسه: إن أوبراين لا يتظاهر، كما أنه ليس مرائياً فهو يؤمن بكل كلمة ينطق بها،
ولم يحزن ونستون على شيء قدر حزنه حينما أحس بدونيته الفكرية أمام عقل أوبراين
المتوقد. وراح ونستون يرقب أوبراين صاحب القوام المهيب وهو يغدو ويروح في الغرفة،
فرأى أن أوبراين يفوقه في كل شيء، فليست هنالك فكرة خطرت على بالط ونستون أو حتى
راودته إلا وكان أوبراين على علم مسبق بها وعرف كيف يفندها تفنيداً، لقد احتوى
بعقله عقل ونستون. وما دام الأمر كذلك كيف يمكن أن يكون أوبراين مجنوناً؟ لا ريب
في أنني أنا المجنون. وتوقف أوبراين عن السير وتطلع إلى ونستون وقال له بصوت صارم:
- لا تتصور أنك ستنقذ نفسك يا ونستون مهما
كان استسلامك لنا مطلقا، فما من امرئ انحرف مرة عن جادة الصواب ثم أبقينا على
حياته، وحتى لو اخترنا أن نتركك تعيش إلى أن ينقضي أجلك فتموت ميتة طبيعية، فلن
يمكنك أبداً أن تفلت من قبضتنا وما حدث لك هنا سيعيش معك إلى أبد الدهر. فعليك أن
تعي ذلك سلفاً. إننا سنسحقك إلى درجة لا يمكنك بعدها أن تعود بحياتك إلى سيرتها
الأولى، وستحدث لك أشياء لن يمكنك أن تبرأ من آثارها حتى لو عشت ألف عام. وأبداً
لن تقدر ثانية على الشعور بما يشعر به الأحياء. إن كل شيء سيموت داخلك ولن تعود
قادرًا على الحب أو الصداقة أو الاستمتاع بالحياة أو الضحك أو حب الاستطلاع أو
الشجاعة أو الاستقامة. ستكون أجوف لأننا سنعصرك حتى تصبح خواء من كل شيء ثم نملأك
بذواتنا.
وتوقف أوبراين وأشار إلى الرجل ذي المعطف
الأبيض، وأحس ونستون بأن جهازاً ثقيلاً قد دفع إلى مكان ما خلف رأسه. وجلس أوبراين
بجانب السرير حتى يصبح وجهه محاذياً لوجه ونستون. وقال موجها أمره إلى الرجل ذي
المعطف الأبيض:
- ثلاثة آلاف.
وفي الحال أحس ونستون بأن ضمادتين ناعمتين
مبللتين تضغطان على صدغيه، فارتعد من الخوف حينما شعر أن ألماً يتدفق في جسده، إنه
لولى جديد من الألم، لكن أوبراين ربت على كتفه مطمئناً إياه:
- لا تخف فلن يؤذيك الألم هذه المرة، ولكن
أبقِ عينيك مركزتين في عيني.
وفي تلك اللحظة أحس ونستون بانفجار مدوّ أو
ما بدا أنه انفجار، ومع ذلك لم يكن واثقاً إن كان سمع صوتا أم لا، لكن مما لا ريب
فيه أنه كان مصحوباً بوميض ضوء تزيغ له الأبصار، لم يصبه ذلك بأذى وإن شعر أنه
انبطح على وجهه رغم أنه كان في الأصل مستلقياً على ظهره، وتملّكه شعور غريب بأنه
قد قذف به إلى هذا الوضع إثر ضربة مخيفة سحقته سحقاً، وأحس بأن شيئاً ما قد حدث
داخل رأسه، وعندما استعادت عيناه قدرتهما على التركيز تذكر من هو وأين هو وعرف
الوجه الذي كلان يحدق في عينيه. بيد أنه أحس بأن فراغاً واسعاً قد حدث في رأسه
وكأنما قطعة من دماغه قد انتزعت انتزاعاً.
وقال أوبراين: «لن يطول بك هذا الحال، لكن
انظر إلى عيني، أي دولة تحاربها أوقيانيا الآن؟»
وفكر ونستون ملياً، فأدرك ما يعنيه بكلمة
أوقيانيا، وعرف أنه احد مواطني أوقيانيا، كما تذكر إيستاسيا وأوراسيا، لكنه لم يدر
من في حرب مع من، بل إنه لم يكن يعي أن ثمة حرباً قائمة.
فأجاب: «لا أذكر».
فقال أوبراين: «إن أوقيانيا في حالة حرب مع
إيستاسيا، هل تذكر ذلك الآن؟ »
- نعم.
- لقد كانت أوقيانيا في حرب دائمة مع
إيستاسيا، فمنذ بداية حياتك ومنذ نشأة الحزب ومنذ بداية التاريخ وهذه الحرب مشتعلة
دون توقف، إنها الحرب نفسها. فهل تذكر ذلك؟
- نعم.
- منذ أحد عشر عاماً ابتدعت يا ونستون خرافة
عن ثلاثة رجال كانوا قد أدينوا بالموت جزاء خيانتهم، وزعمت أنك رأيت قصاصة من
الورق تثبت براءتهم، إن مثل هذه القصاصة لم يكن لها وجود على لإطلاق، لقد اخترعتها
ثم رحت تؤمن بها فيما بعد، هل تذكر اللحظة التي اخترعت فيها هذه الخرافة؟
- نعم.
- منذ فترة قصيرة رفعت يدي إليك فرأيت خمس
أصابع، هل تذكر ذلك؟
- نعم.
ورفع أوبراين أصابع كف يده اليسرى وقد أخفى
الإبهام وسأله: إنها خمس أصابع، هل ترى خمس أصابع؟
- نعم
ولقد رآها فعلاً خمساً ولكن للحظة عابرة قبل
أن يتغير المشهد أمام ذهنه. لقد رآها خمسة كاملة لا عيب ولا عاهة فيها، ثم لم يلبث
أن عاد كل شيء طبيعياً، وراحت تتداعى عليه من جديد مشاعر الخوف والكراهية والحيرة.
لكن لفترة لم يدرك مداها، لعلها كانت لحظات من اليقين المشرق كان فيها كل إيحاء
جديد من إيحاءات أوبراين يملأ جزءاً من الفراغ الذي في رأسه ويصبح حقيقة مطلقة،
لحظات يمكن فيها أن يكون اثنان واثنان يساويان ثلاثة أو خمسة حسبما يتطلب الأمر.
وما إن رفع أوبراين يده من فوق رأسه حتى انقشع عنه ذلك الكابوس. ورغم أنه لم يستطع
أن يستعيده ثانية، فقد ظل يذكره كما يذكر المرء واقعة حية ألمّت به منذ فترة بعيدة
كان فيها شخصاً مختلفاً.
وقال أوبراين: «لعلك ترى الآن أن ما حدثتك به
ممكن».
فأجاب ونستون: «نعم».
نهض أوبراين وقد ارتسمت على وجهه علامات
الرضا، وعن يساره رأى الرجل ذا المعطف الأبيض يكسر أنبوبة ثم يسحب بمحقنة ما بها
من سائل. والتفت أوبراين إلى ونستون وعلى شفتيه ابتسامة وهو يعيد تثبيت نظارته فوق
أنفه جريا على عادته القديمة وقال:
- هل تذكر ما دونته في مذكراتك من أنه لا
يهمك أن أكون صديقاً أو عدواً ما دمت على الأقل شخصاً يفهمك ويمكنك أن تتحدث إليه؟
لقد كنت على صواب، إنني أجد متعة في الحديث إليك، إن عقلك يستهويني لأنه يشبه عقلي
في كل شيء، عدا أنه مصاب بمس من الجنون. لكن قبل أن ننهي هذه الجلسة يمكنك إذا شئت
أن تلقي علي بضعة أسئلة.
- أي سؤال أريد؟
- نعم أي سؤال. ولاحظ أوبراين أن عيني ونستون
معلقتان بالقرص، فطمأنه أنه قد فصل عنه التيار وقال له: «هات سؤالك الأول».
فقال ونستون: «ماذا فعلتم بجوليا؟»
فابتسم أوبراين ثانية ثم قال: «لقد خانتك يا
ونستون بلا إبطاء أو تحفّظ. إنني لم أر في حياتي، إلا نادراً، أحداً يثوب إلى رشده
بمثل هذه السرعة، ولو أنك رأيتها الآن لما عرفتها بعد أن اجتثثنا كل ما علق بها من
أدران التمرد والخداع والجهالة والميول الجنسية. لقد حدث لها تحول تام وأصبحت
نموذجًا يحتذى ويدرس».
- هل عذبتموها؟
ولم يجب أوبراين عن هذا السؤال بل قال: «هات
سؤالك الثاني».
- هل للأخ الكبير وجود؟
- لا ريب أنه موجود وكذلك الحزب موجود، ففي
الأخ الكبير يتجسد الحزب.
- وهل هو موجود مثلي، كما أنا موجود وبالشكل
ذاته؟
فأجابه أوبراين: «إنك غير موجود».
ومرة ثانية أحس ونستون بنوبة من العجز
تجتاحه، فقد كان يعرف، أو يمكنه أن يتخيل، أن الحجج التي يُدفع بها للتدليل على
عدم وجوده هي مجرد هراء لا معنى له ولا تعدو أن تكون مجرد تلاعب بالكلمات. ألا
تحتوي عبارة «أنك غير موجود» على سخف منطقي؟ ولكن ما الجدوى من إن تقول ذلك؟
وارتعد عقله عندما فكر في الحجج الجنونية القاطعة التي سيفحمه بها أوبراين.
وقال بإعياء: «اعتقد أنني موجود، أنني أعي
ذاتي، لقد ولدت وسوف أموت، ولي ذراعان وساقان وأشغل حيزاً في الفضاء ولا يستطيع
جسم آخر أن يشغل الحيز نفسه في الوقت نفسه. بهذا المعنى أسال:
- هل للأخ الكبير وجود؟
- ليس لما تقول أي أهمية، إنه موجود.
- وهل سيموت الأخ الكبير في يوم من الأيام؟
- طبعاً لا، كيف يمكن أن يموت؟ هات سؤالك
التالي.
- هل لحركة الأخوة وجود؟
- هذا ما لن تعرفه يا ونستون، ولئن رأينا أن
يطلق سراحك بعد أن نفرغ من تطهيرك، ولئن امتد بك الأجل حتى تبلغ التسعين من العمر
فلن تعلم ما إذا كان جواب سؤالك هذا نعم أو لا. وما دمت حياً سيظل هذا السؤال هو
اللغز المحير الذي لن يجد عقلك حلاً له.
وخيم على ونستون الصمت لبعض الوقت، وراح صدره
يعلو ويهبط بسرعة أكثر قليلاً، ولم يكن قد سأل بعد السؤال الذي خطر بباله أولاً،
وكان يشعر أن عليه أن يوجه هذا السؤال لكن لسانه لم يكن يطاوعه. أما أوبراين فقد
ارتسمت على وجهه مسحة تهكم، بل حتى نظارته أخذت تكتسي بالمسحة نفسها. وفجأة خطر
لونستون أن أوبراين يدرك ما يدور بخلده ولا بد أنه على معرفة بالسؤال الذي يعتزم
أن يسأله. ولم يكد ينتهي من هذه الفكرة حتى اندفعت الكلمات من بين شفتيه:
- ماذا يوجد في الغرفة 101؟
ولم يتغير التعبير المرتسم على وجه أوبراين
وأجاب بجفاء:
- إنك تعرف ماذا يوجد في الغرفة 101 يا
ونستون، بل إن كل شخص يعرف ماذا يوجد في هذه الغرفة.
وأشعار أوبراين بإصبعه إلى الرجل ذي المعطف
الأبيض وبدا جلياً لونستون أن الجلسة قد انتهت، وسرعان ما انغرست إبرة في ذراعه
راح على إثرها في نوم عميق.